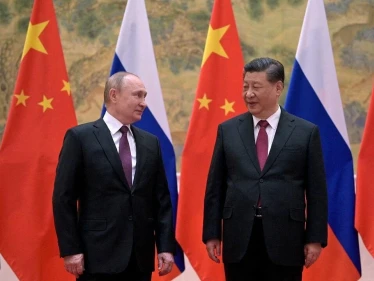بينما كانت الأنظار تتجه إلى نيويورك مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، راجت التوقعات حول احتمال توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل برعاية دولية، غير أن هذا الاتفاق لم يرَ النور حتى اللحظة، ما أثار تساؤلات عديدة عن الأسباب الكامنة وراء التأجيل، وحدود التلاقي أو التباعد بين الطرفين، ويبدو أن الصورة أكثر تعقيداً مما قد يوحي به المشهد الدبلوماسي، إذ تتداخل حسابات الداخل السوري مع الشروط الإسرائيلية، وسط مراقبة لصيقة من القوى الدولية.
لماذا لم يُوقَّع الاتفاق على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن غياب التوقيع لم يكن مجرد صدفة أو نتيجة تفاصيل تقنية مؤجلة، بل يعكس فجوة ثقة عميقة بين الطرفين، فإسرائيل وبعض الدول ترى أن الحكومة الانتقالية في دمشق ما زالت في طور تثبيت سلطتها بعد سقوط نظام الأسد، وبالتالي يصعب التعامل معها كضامن فعلي لأمن الحدود وضبط الفصائل المسلحة.
وهذا ما يؤكده الدبلوماسي السوري السابق بشار حاج علي، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز، ويقول: "السبب الجوهري هو الترقب والاختبار، النظام الانتقالي بقيادة أحمد الشرع لا يزال في طور تثبيت سلطته وبسط نفوذه على كامل أجهزة الدولة. من وجهة نظر إسرائيل والدول الضامنة، فإن التوقيع مع طرف لم يُثبت بعد أنه قادر على فرض الأمن وضبط الميليشيات هو مقامرة غير محسوبة".
ويضيف: "باعتقادي التأجيل رسالة واضحة: المطلوب ضمانات فعلية، وليس مجرد تعهدات خطابية، وربما محاولة ابتزاز من قبل الكيان المحتل."
ويكشف أن ما جرى في نيويورك لم يكن إخفاقاً بروتوكولياً، بل خطوة محسوبة من جانب تل أبيب والقوى الراعية بانتظار اختبارات على الأرض تثبت أهلية الحكومة السورية.
انتقادات الشرع لإسرائيل: مناورة أم رفض ضمني؟
أثارت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تضمنت انتقادات حادة لإسرائيل وسياساتها التوسعية، جدلاً حول طبيعة الرسائل التي أراد إيصالها، لا سيما أنها تحمل رمزية كونها أول كلمة لرئيس سوري بهذا المحفل منذ 6 عقود، والبعض قرأها كرفض ضمني للشروط الإسرائيلية، فيما اعتبرها آخرون تكتيكاً تفاوضياً بحتاً.
وهنا يوضح بشار حاج علي: "الانتقاد في هذه المرحلة يُقرأ تكتيكياً أكثر منه استراتيجياً فهو يؤدي وظيفتين أساسيتين: شرعية داخلية عبر التأكيد أن النظام الجديد لم يتنازل عن الثوابت الوطنية لتفادي اتهامات الشارع بالانبطاح. وثانياً موقف تفاوضي، ورفض غير مباشر للشروط الإسرائيلية التي تُعد مجحفة، مثل فرض مناطق منزوعة السلاح على نحو غير متوازن".
في المقابل يرى الخبير أنه قد يكون خطاب الشرع مناورة لرفع ثمن التنازلات لاحقاً إذا فُرضت ظروف دولية أو داخلية تضطره لذلك.
ولا يبدو أن دمشق أغلقت الباب أمام التفاهم، لكنها اختارت استخدام الخطاب الحاد كأداة لتثبيت موقعها التفاوضي أمام الداخل والخارج معاً.
شروط نتنياهو: خطوط حمراء أم هوامش مرنة؟
منذ البداية، وضعت إسرائيل شروطاً اعتبرتها ضرورية لأي اتفاق، في مقدمتها إقامة منطقة منزوعة السلاح وضمان حماية الطائفة الدرزية، وهذه الشروط توصف في إسرائيل بأنها أساسية لحفظ أمنها الاستراتيجي، لكنها أيضاً تحمل أبعاداً سياسية داخلية.
وهنا يقول حاج علي: "المنطقة المنزوعة السلاح مطلب استراتيجي ثابت لإسرائيل، يكاد يشكّل خطاً أحمر لا رجعة عنه، والنقاش سينحصر في العمق الجغرافي للقوات المسموح بها وطبيعتها (شرطة محلية مقابل قوات عسكرية)".
أما حماية الدروز -بحسب الخبير- فهي قضية ذات بعد سياسي–اجتماعي في الداخل الإسرائيلي، قابلة للتفاوض في آلياتها التنفيذية أكثر من جوهرها.
ويضيف: "دمشق ستعتبرها تدخلاً في شؤونها، مما يفتح مجالاً لصياغة حلول وسطية بضمانات دولية، كما حصل قبل أيام في عمان."
ويتضح من هذا الطرح أن إسرائيل لن تتراجع عن جوهر مطالبها، لكنها قد تدخل في تفاصيل مرنة حول طريقة تطبيقها، شرط أن تجد ترتيبات دولية تمنحها الاطمئنان الكافي.
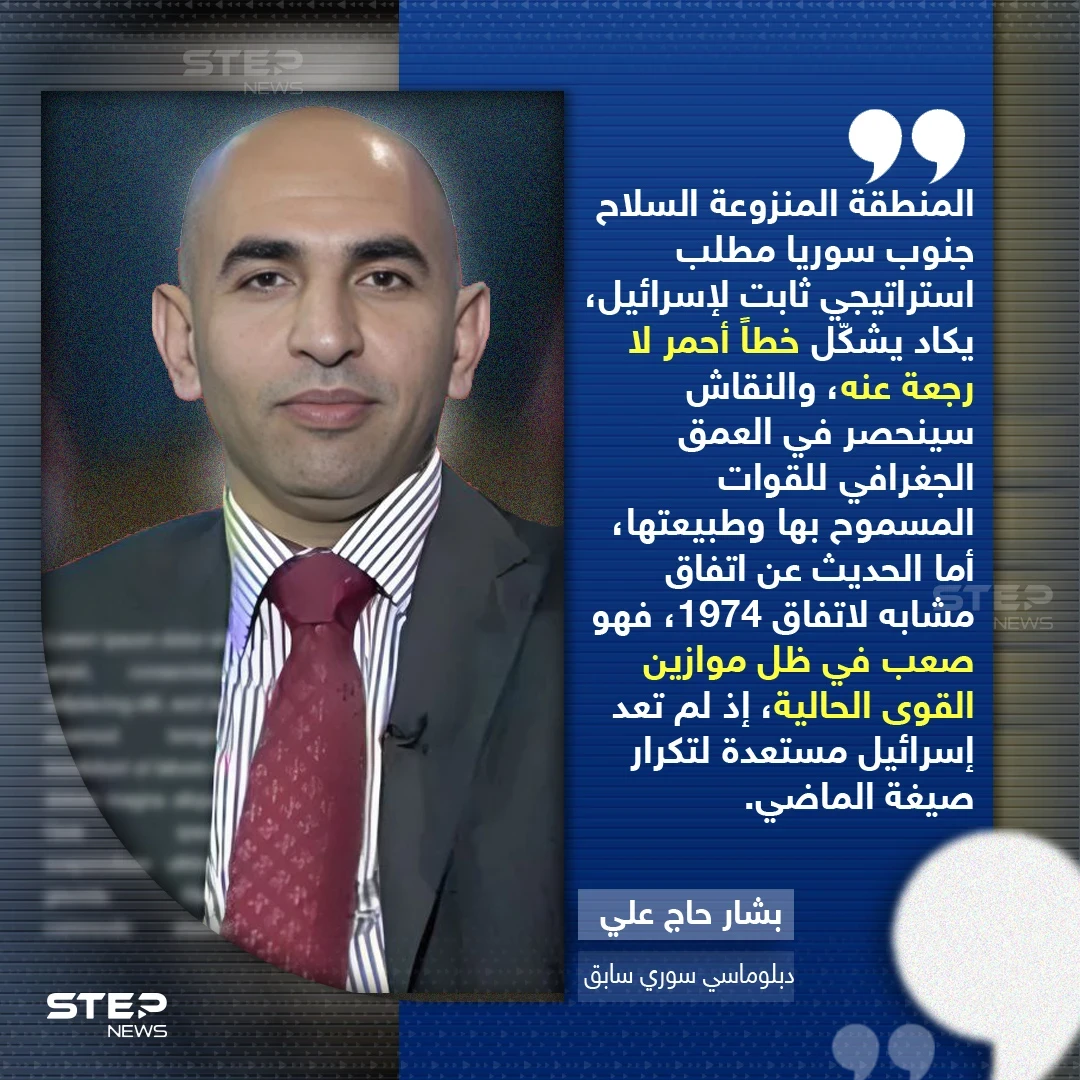
أوراق الضغط السورية: بين حدود الماضي وحسابات الواقع الجديد
رغم التحديات، لا تخلو يدي الحكومة السورية من أدوات ضغط، ولو محدودة، فالنظام الانتقالي يسعى لتقديم نفسه كضامن للاستقرار، في مقابل البدائل الفوضوية التي قد تنشأ من انفلات الفصائل المسلحة.
ويعدد حاج علي هذه الأوراق قائلاً: "قدرة النظام الانتقالي على الظهور كضامن للاستقرار مقابل البديل الفوضوي الذي قد تفرضه الفصائل، ثم العلاقات الإقليمية، وأي إشارة إلى مرونة في ملف إيران أو انفتاح على عواصم عربية كبرى (القاهرة، الرياض) ستمنح دمشق وزناً تفاوضياً".
ويتابع: “إضافة إلى ورقة التوقيت، فاستغلال أي أزمة سياسية أو داخلية إسرائيلية للضغط نحو اتفاق سريع، خشية ضياع الفرصة مع حكومة إسرائيلية أكثر تشدداً مستقبلاً.”
لكنّ الخبير يوضح أن استنساخ اتفاق 1974 لم يعد واقعياً، رغم أن دمشق تطالب به او بشيء مشابه له.
ويضيف: “الحديث عن اتفاق مشابه لاتفاق 1974 صعب في ظل موازين القوى الحالية، إذ لم تعد إسرائيل مستعدة لتكرار صيغة الماضي. ما تلمّح إليه تل أبيب عملياً هو تثبيت حدود أمنية جديدة بحكم الأمر الواقع، أي ما يشبه الاعتراف غير المعلن بترتيبات حدودية وفق وجهة نظرها، وهنا يكمن التحدي السوري: القبول بذلك يعني تآكلاً في السيادة، والرفض يفتح الباب لمزيد من التوتر والضغوط.”
وبالتالي المعضلة أمام دمشق تكمن بين القبول بتنازلات قد تُقرأ داخلياً كمسّ بالسيادة، أو رفضها والدخول في مواجهة سياسية وأمنية مفتوحة.
جاهزية الفريق السوري للمفاوضات: بين ضعف الخبرة وفرص المرونة
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يملك الفريق السياسي السوري الانتقالي القدرة على الدخول في مفاوضات طويلة ومعقدة؟ والإجابة تبدو ملتبسة.
يعلّق الدبلوماسي السابق قائلاً: "الفريق الانتقالي يفتقر إلى خبرة مؤسساتية راسخة في مفاوضات بهذا الحجم، وهو ما يطرح مخاطر واضحة: قصور تكتيكي قد يؤدي إلى أخطاء في قراءة النوايا الإسرائيلية، وضعف التماسك الداخلي حيث أن التباينات أو التسريبات قد تعقّد أي مسار تفاوضي. لكن في المقابل، غياب الإرث التقليدي قد يمنحه مرونة وقدرة على طرح مبادرات غير مألوفة، وهو عامل لا يُستهان به."
وبمعنى أن نقص الخبرة قد يشكّل عبئاً، لكنه قد يتحول إلى فرصة لابتكار أساليب جديدة في التفاوض، بعيداً عن الجمود التقليدي.
الارتباط بالملف الداخلي السوري: المصالحة والانتخابات
لا يمكن فصل أي اتفاق خارجي عن الداخل السوري المتشظي، فنجاح المصالحة في السويداء أو إجراء انتخابات تشريعية مقبولة نسبياً سيعزز شرعية الحكومة الانتقالية، ويمكّنها من دخول التفاوض بثقة أكبر.
وهنا يشدد حاج علي: "الاتفاق الأمني متداخل عضوياً مع الملفات الداخلية: مصالحة السويداء نجاحها يعزز صورة النظام كمرجعية وطنية جامعة، وفشلها يفضحه كسلطة ناقصة الشرعية".
ويضيف: "أما الانتخابات التشريعية، فإن جرت بقبول نسبي داخلي وخارجي، ستمنح الشرع شرعية أكبر في أي تفاوض. كما أن الاتفاق مع إسرائيل، إن تحقق، قد يُستخدم كورقة انتخابية، لكنه في الوقت نفسه محفوف بمخاطر رد فعل شعبي غاضب."
وهذه المعادلة المعقدة تجعل من أي تفاهم مع إسرائيل سيفاً ذا حدين: مصدر قوة وشرعية، أو سبباً في اهتزازها.
اتفاق يبتعد
ما بين تعقيدات الداخل السوري وحسابات الأمن الإسرائيلي، يبدو أن توقيع اتفاق أمني شامل لا يزال بعيد المنال، فإسرائيل تتمسك بمطالب تعتبرها خطوطاً حمراء، بينما تحاول دمشق لعب أوراقها المحدودة لانتزاع اعتراف دولي وسيادة منقوصة على الأرض، وفي الوقت ذاته، لا تستطيع الحكومة الانتقالية تجاهل حساسية الرأي العام الداخلي، خصوصاً في ظل مساعي المصالحة والانتخابات المرتقبة.
وفي المحصلة، قد يكون السيناريو الأقرب هو تفاهمات مرحلية أو إطار مبدئي برعاية دولية، يؤجل البتّ في القضايا الأكثر حساسية إلى وقت لاحق، غير أن هذا التأجيل لا يخلو من مخاطر، إذ يمنح كل طرف فرصة لتعزيز أوراقه، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى إطالة أمد الاضطراب الحدودي، ومع استمرار التوازن الدقيق بين الضغوط والفرص، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تستطيع دمشق وتل أبيب كسر حلقة الشروط المتبادلة، أم أن الانتظار سيظل هو القاعدة في المرحلة المقبلة؟